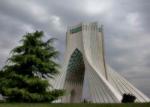المطلع على الصحف والمواقع الإعلامية المحلية ( في اليمن ) هذه الأيام، يلاحظ كثرة الانتقادات التي توجه من خلالها للسلفية والسلفيين. ومع أن معظم تلك الانتقادات المقصود بها نقد ممارسات بعض المحسوبين على السلفية، إلا أن الهجوم كثيرا ما يعمم، فيطال الدعوة السلفية ذاتها كمنهج، بل ومحمد بن عبد الوهاب ذاته، وهذا شائع لدى الكثير من أنصاف المثقفين، ولدى الطابور الإيراني الخامس، لاسيما ممن يكتبون في صحف ومواقع المعارضة، وكأن الدعوة السلفية هي الغريم، وكأن أولئك السلفيين في صعدة أو معبر أو صنعاء، حجة على الدعوة السلفية، وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
ولذا أحببت هاهنا أن أعطي فكرة حول نشأة الدعوة السلفية وحول مؤسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحول الأفكار والمبادئ التي قامت عليها. وهذه وجهة نظر شخصية، وليست انتصارا لفلان أو علان، وأنا لا أزعم لنفسي أني من أصحاب الشأن، ومقالي هذا يأتي تحت شعار " أحب الصالحين ولست منهم".
العالم الإسلامي غداة قيام الدعوة السلفية:
كان العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي- وهو القرن الذي ظهرت فيه الدعوة السلفية الإصلاحية في نجد - يعيش أوضاعاً سيئة للغاية من جميع النواحي الدينية والدنيوية. ومن مظاهر ذلك:
- كثرة البدع والشركيات ومحدثات الأمور، وغلبة الجهل على عامة المسلمين، لاسيما الجهل بالعقيدة، فانتشرت بينهم حمى التعلق بغير الله، في الدعاء والاستعانة والاستغاثة، والذبح والنذر لغيره سبحانه وتعالى، وتقديس الأشخاص الأموات والأحياء، والاعتقاد بالمشايخ والأولياء وأصحاب الطرق وفي جلبهم للنفع ودفعهم للضر، وشد الرحال لزيارة القبور والأضرحة والمشاهد، ودعوتها رغباً، ورهباً، والطواف حولها، وتزيينها وزخرفتها وإقامة القباب والمباني عليها.بل وحتى تعظيم الأشجار والأحجار، والاعتقاد ببركتها.
- سيادة التصوف سيادة شبه تامة في واقع المسلمين، وفي حياتهم الاجتماعية والدينية حتى أنه كان يتعذر منذ ابتداء العصر العثماني في القرن التاسع الهجري، أن تجد عالما غير منتسب لطريقةٍ من الطرق الصوفية التي انفردت بالساحة الإسلامية طولا وعرضا، بما باتت تتضمنه الطقوس والشعائر الصوفية من بدع وشطحات، ومن تجاوزات تمسّ العقيدة، وتجاوزات تخص الشريعة، ومن استغراق في الغيبيات وإيمانٍ بالخزعبلات، والأساطير التي ترسّبت ورسخت في الأذهان، واتخذت لدى العامة صورة مسلمات، ومن حلقات رقص وتمايل.
- إعراض كثير من الناس عن الدين، لا يتعلمونه، ولا يعملون بمبادئه، إلا ما يوافق الأهواء، وكثرة لجوئهم إلى الكهان المشعوذين والسحرة والدجالين، مع كثرة المفسدين وندرة المصلحين والقائمين بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
– شيوع التعصب المذهبي المقيت والأعمى، بين عامة المسلمين وخاصتهم، بشكل لم يسبق له مثيل، إلى أن وصل الحال في المسجد الحرام، وقبلة المسلمين، أن افترق المسلمون في صلاة الجماعة، أربع فرق فصار أتباع كل مذهب يصلون وحدهم. بما يترتب على ذلك من فوضى وتشويش.
ولم يكن الواقع السائد في نجد، حينذاك، وهو المكان الذي انطلقت منه الدعوة السلفية، يختلف كثيرا عن الواقع السائد في كثير من البلاد الإسلامية الأخرى، بما فيها أرض الحرمين الشريفين، إن لم يكن الواقع في نجد هو الأشد سوءا من جميع النواحي، فقد كانت نجد من الناحية الدينية والفكرية، فريسة للجهل والبدع والخرافات، وسيادة عادات الآباء والأجداد، التي ما أنزل الله بها من سلطان، إلى جانب استفحال عادة التبرك بقبور الصالحين مثل قبر الصحابي الجليل: زيد بن الخطاب، وقبر آخر زعموا أنه للصحابي الجليل ضرار بن الأزور، وتعظيم الأحجار والأشجار والمغارات، وسيادة التصوف الحافل بالبدع والمنكرات، كمذهبي ابن عربي وابن الفارض، وكان ينتشر فيها السحرة والكهنة، وسؤالهم وتصديقهم وليس هناك منكر إلا من شاء الله، وكان العلم الشرعي فيها قد تراجع إلى أدنى مستوى له، واقتصر على الحاضرة، وكانت اهتمامات العلماء مقصورة على الفقه غالباً، أما عنايتهم بالعقيدة والحديث والتفسير واللغة فهي قليلة، كما أن جهود العلماء أمام البدع والمنكرات كانت ضعيفة، ولا تكاد تذكر.
وأما من الناحية السياسية فقد كانت نجد حينذاك، مقسمة إلى إمارات ومشيخات صغيرة، تغلب عليها السمة القروية والبدوية، وتهيمن عليها الأعراف والعادات الجاهلية، ويكثر فيها الظلم والجور، وتتحكم في أصحابها العصبية القبلية البغيضة. وكانت مظاهر الفرقة والتناحر والحروب هي التي تهيمن على علاقة تلك المشيخات والإمارات ببعضها، بعضا عادةً، كما كانت العلاقات بين البادية والحاضرة في عداء مستمر، وسلبٍ ونهب في الأعم الأغلب، وذلك لعدم وجود السلطان الذي يجمع الشمل، ويحفظ الأمن، ويقيم العدل.
نشأة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
وفي هذه الفترة الحرجة والعصيبة، من تاريخ أمتنا، وفي ظل هذا الواقع الحالك والأليم، الذي كانت تعيشه نجد والعالم الإسلامي، ظهر محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي، (1115- 1205هـ /1703-1792م )، في بلدة العيينة الواقعة شمالي غرب الرياض، فتى عربيا، باهي الطلعة، حسن الهيئة، سليم الفطرة، متوقد الذهن، سريع البديهة، بعيد النظر، عالي الهمة، ميمون النقيبة، ذو إباء وشهامة ورجولة وعقل. نشأ على حب العلم والتفقه في الدين، في بيتٍ كريمٍ فاضلٍ كان شعاره العلم والعمل للدين. فحفظ القرآن وأتقنه قبل بلوغه العشر، واستقى منه عزته، وغذا فيه شعوره الديني المرهف الذي لازمه طوال حياته، وقضى فترة صباه ويفاعته ينهل من المعارف والعلوم الشائعة في عصره، بكل جدٍ واجتهاد، كعلوم القرآن والسنة والتفسير، والنحو، والسيرة النبوية والفقه - وفي مقدمته الفقه الحنبلي - وأبدى همة كبيرة في تحصيل العلم النافع، من والده قاضي العيينة ومفتي أهلها، ومشائخ بلدته أولا، ثم بعد ذلك أخذ يضرب من أجله أكباد الإبل، فسافر إلى مكة والمدينة والبصرة، والأحساء، وغيرها، وتتلمذ على كثير من العلماء الذين كان لا زال يحفل بهم الحرمان الشريفان، ومساجد البصرة ومعاهدها، حيث أخذ من العلم أحسنه وأنفعه وأرفعه، وتفوق على أقرانه في سرعة الحفظ، وحسن الفهم، وعمق الاستيعاب، وأظهر ألمعية ونبوغاً وتميزاً، وبلغ رتبة المجتهد بكل جدارة، بل وأوتي قدرة غير عادية حتى في الخط وسرعة الكتابة. وقد أعجب أيما إعجاب بكتب الإمام الجليل تقي الدين ابن تيمية (661 – 728هـ) وكتب تلميذه الإمام ابن القيم الجوزية (691- 751هـ) ، وتأثر بأفكارهما في الاعتقاد والفقه أيما تأثر، لاعتقاده أنها تمثل السُنّة النبوية.
وفوق كل ذلك، وفوق ما كان عليه من الورع والتقوى، كان غيورا على الدين، وخاصة على عقيدة توحيد رب العالمين، متحفزا للذب عنها، ولتنزيه الله جلّ وعلى عن كل ما لا يليق بوجهه الكريم، حريصا على أن يقرن العلم بالعمل، وعلى تصديق ما وقر في القلب بالطاعة والعبادة، تأسيا بسيد المرسلين، وإقتداءً بمن اهتدى بهديه من السلف الصالحين، الذين فهموا معنى كلمة التوحيد حق الفهم، وصدقوه بأقوالهم وأفعالهم، وكانوا خير من جسد مبادئ الإسلام وقيمه ومثله العليا، على أرض الواقع، وحملوا أمانته إيمانا ونشرا وجهادا.
وقد فتحت هذه الرحلات العلمية أمامه آفاقا جديدة، وأضافت إلى معلوماته الشيء الكثير، وأطلع من خلالها على أحوال العالم الإسلامي، وما وصل إليه المسلمون من ركود وفسادٍ وجهلٍ، ومن انحرافاتٍ في مجال العقائد والعبادات، يندى لها جبين المسلم الموحد، ولا يرضاها مؤمن، وهاله أن يرى كيف أن الدين الذي أعز الله به هذه الأمة، لم تعد أحكامه مراعاة أو مطبقة، اللهم إلا القشور منها.
ونشبت بينه وبين علماء هذه الأمصار أثناء إقامته فيها، خلافات وخصومات، وخاصة علماء العراق، لأن الشيخ كان غيورا على الدين، مفرط الحساسية في كل ما يمس عقيدة التوحيد، جريئا في إنكار البدع والمعتقدات الباطلة، التي كانت تزخر بها مجتمعات هذه الأمصار، كالتوسل والاستغاثة بغير الله، ونداء المخلوقين في الشدائد، وتعظيم قبور الأنبياء والصالحين، والطواف حولها وأكل ترابها.. فكان يشجب هذه المظاهر وغيرها علنا، ويصرّح بذلك ويظهره لكثير من جلسائه، وكان يعيب على العلماء سكوتهم وتغاضيهم عنها، رغم مخالفتها لصريح الآيات والأحاديث، وكان ينعى عليهم موقفهم السلبي إزاءها، وانعدام المبادرة لديهم للقيام بما فرض الله عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إنه ونتيجة لما جبل عليه من الجرأة في الحق، وشدة خوفه من الله، وفرط إحساسه بالمسئولية الملقاة على عاتقه، وإيمانه بقاعدة " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " تجاسر حتى على نقد بعضٍ من أساتذته ومعلميه. فكان بعضا من هؤلاء وأولئك يركبهم العناد والتعصب للباطل، فيردوا على ذلك بإقرار العادات والممارسات الشائعة بما فيها من الطوام والبدع، التي تمس جوهر العقيدة، من جهة، وبمهاجمة الشيخ، والتشنيع بما يدعو إليه، واتهامه بشذوذ الرأي، ومخالفة الإجماع..الخ. من جهة أخرى.
وبتلك الحصيلة من العلم النافع، وبما قذفه الله في قلبه من اليقين، وقوة البصر والبصيرة، وما أضفى عليه من الوقار والهيبة، وبما أكتسبه من خبرة بواقع المسلمين من خلال رحلته العلمية الطويلة، عاد محمد بن عبد الوهاب إلى أهله ووطنه في نجد، وهو أكثر تصميما على التغيير، وكان حينذاك قد تجاوز سن الـ35 سنة.
مبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
عاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى بلدته في نجد، من رحلته العلمية تلك، وقد ترسخت في نفسه وعقله العناصر الأساسية، التي تكّون شخصية الداعية الإصلاحي المسلم، كالعلم والاستنارة الفكرية والعقلية، وقيم الدين الحق، وقوة العزم والإرادة، والصفات الفاضلة الرفيعة، واكتمال الرجولة، والإحاطة الواعية بالواقع، والفصاحة وجودة البيان، والصبر والحلم والجلد، واسترخاص الحياة، والاستهانة بالمادة، والتمسك بالعفة، إلى آخر الصفات والمزايا التي يتميز بها المصلحون الدينيون العباقرة في كل زمان ومكان.
وقد عزّ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يرى أهله وقومه، بل والمسلمون من حولهم، على ذلك الحال البائس من التخلف الديني والفكري، والانحراف العقدي، والبعد عن جوهر الدين، وعن الصراط المستقيم، والوقوع تحت سطوة وسلطان البدع والأوهام والخرافات، فانبرى فيهم، داعيةً للإصلاح، وشمر عن ساعد الجد، لتطهير المجتمع من الأوضار، وإعادة بنائه على أسسٍ عقائدية إسلامية صحيحة وراسخة.
"وقامت دعوته المعروفة على التوحيد المطلق الخالص من رفض الجبرية وفكرة الحلول والاتحاد، ومع تأكيد مسئولية الإنسان.. كما قامت دعوته على فتح باب الاجتهاد والتماس الحلول من المصادر الرئيسية للشريعة، وهي القرآن والسنة والإجماع ـ مع عدم التقيد بمذهب معين من المذاهب السنية الأربعة".
ومعنى ذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأت بشيء جديد مبتدع، ولم يدعو إلى أمر مستحدثٍ في الدين، تقصر عن فهمه العقول، ويحتار فيه أولو الألباب، ولم يقل شيئا يخرج عن نطاق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان عليه عليهم، وما دعا إليه العلماء المصلحون من قبله، من أهل السنة والجماعة على امتداد التاريخ الإسلامي، من أحمد بن حنبل (164- 241هـ)، إلى عبد الله بن ياسين، إلى العز بن عبد السلام، إلى تقي الدين أحمد بن تيمية ، وغيرهم. بل حتى ما دعا إليه العلماء المصلحون المعاصرون له مثل الإمامين: ابن الأمير الصنعاني، ومحمد بن علي الشوكاني ( 1758- 1823م ).
وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب - وفقا لرأي الباحثين - من تلاميذ فكر تقي الدين ابن تيمية "الفقيه السوري الجريء الذي أحسن التعبير عن آراء الحنابلة"، حتى أنه ليُقال: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لم يكن سوى وسيلة لإماطة اللثام عن الأفكار الإصلاحية النيرة لهذا الإمام العالم المجاهد الفذ، التي أكد عليها في القرن السابع الهجري، والتي تم تجاهلها وتناسيها نتيجة للإنحطاط الفكري الشامل الذي عرفته الأمة في القرون الأخيرة. ومن ثم إعادة إيقاظ تلك الأفكار ونشرها وتفعيلها من جديد، وتأصيلها في واقع الحياة، ولاسيما الأفكار التي تضمنها كتابه القيم « السياسة الشرعية » وذلك طبعا عن إيمانٍ وبصيرة وعلم وفهمٍ، بعيدا عن الارتجال والتهور، وبعد تدقيقٍ وتحقيقٍ وتمحيص، ودون أي تحزب أو تعصب، أو مكابرة. مع إفساح الصدر للرأي الآخر، وقبول حجته إذا ثبت أنها توافق الكتاب والسنة، وطرح ما يخالفها من آراء أقرب المقربين إليه من أئمته. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن متعصبا للرجال قط، وإنما كانت عصبيته لكتاب الله وسنة رسوله، وهو لم يقل بعصمة أحد من السابقين، حاشا المعصوم صلى الله عليه وسلم، والشيخ محمد بن عبد الوهاب هو القائل: « أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم وأرجو أني لا أردُّ الحق إذا أتاني بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلها على الرأس والعين.. ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق ».
وما يميز دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو أنها دعوة تجديد إصلاحية إسلامية ذاتية، استمدت شرعيتها من الدين مباشرة، ونشأت مستقلة تنادي بالعودة إلى الدين الحق ( عقيدة وشريعة ومنهج حياة) بعيدا عن أي مؤثر خارجي، فهي - على سبيل المثال - " لم تتأثر بالفكر الغربي الذي لم يكن قد وفد بعد، لا في مناهجها التجديدية، ولا في موادها وأدواتها الفكرية، ولا في هيئتها الحركية والتنظيمية".
مراحل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
من بلدة حريملاء في نجد، في حدود سنة 1153هـ - وهو العام الذي مات فيه والده - انطلقت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، التي بدأها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى العلم والتعلم، والرجوع إلى الإسلام الصافي، والتنديد بالخرافات والبدع المنتشرة والشائعة في مجتمعه، وما تخللها من مظاهر الشرك والوثنية التي تمس جوهر الدين، وتتعارض مع مبدأ توحيد لله، وإفراده بالعبودية، والدعاء والعبادة.
ومن الواضح إن أول ما بدأ به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو الدعوة لإصلاح العقيدة – عقيدة التوحيد- وتطهيرها مما علق بها من مظاهر الشرك. وكانت هذه هي الغاية الأولى للدعوة السلفية، وهي الأساس لأي عملية إصلاح ديني، لكون العقيدة هي جوهر الإيمان، وهي الركن الأعظم من أركان الدين، "وهي القضية الكبرى بين الأنبياء وخصومهم، وكذلك بين الدعاة والمصلحين وخصومهم" وإذا صحت العقيدة صح الإيمان، واستقامت باقي أمور الدين.
بيد أن الشيخ لم يستمر طويلا في بلدة حريملاء، نظرا لا نعدام النظام وسيادة الفوضى فيها، ولذا فقد تركها وآثر التوجه إلى العينية مسقط رأسه. وفي العينية صادفت الدعوة قبولا نسبيا، واشتهر أمرها، وقوي فيها أمر الشيخ إلى حد ما، فشرع في الحملة على مظاهر الفساد، وفي تغيير المنكر بلسانه ويده، فقام هو وأنصار الدعوة، بهدم القباب المبنية على القبور، وفي مقدمة ذلك القبة المنصوبة على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك مثيلتها المنصوبة على القبر المزعوم للصحابي ضرار بن الأزور، رضي الله عنه، وقاموا بقطع الأشجار التي كان الجهال يتبركون بها، وفي تطبيق الحدود الشرعية، وإلزام الناس بالصلاة، والأمر بصلاة الجماعة في المسجد. وكذلك فعل في بلدة الدرعية، التي كانت مستقره الأخير، منذ سنة 1158هـ.
ولا حظوا أن التغيير باليد، وتطبيق الحدود الشرعية، وإلزام الناس بالصلاة، وغير ذلك من أمور تتطلب الإجبار أو استخدام القوة، كانت تتم بمعرفة وإرادة سلطان البلاد، وبتوجيهٍ منه، وفي ظل رعايته، وتحت إشرافه، وكان السلطان في المرحلة الأولى لانطلاق الدعوة هو الأمير عثمان بن حمد بن معمر(ت 1163هـ )، أمير العينية، ثم كان بعد ذلك الأمير محمد بن سعود، ت(1179هـ/ 1765م)، أمير الدرعية - الذي تحمس لأفكار الشيخ الإصلاحية، وتحالف معه من أجل نشرها، وتطبيقها في الواقع.
وهذا حقيقة من فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن مظاهر تفكيره العقلي العملي. فهو قد حرص منذ اللحظات الأولى لانطلاقة دعوته على إقناع السلطان الذي يحكم البلاد الذي هو فيها، بتبنيها والعمل بموجبها. فالحق لا بد له من قوة تحميه، ولأن الدعوة في هذه الحالة تكون أكثر قبولا لدى الناس، وأبعد عن الاستهتار بها، أو التشويش عليها، من قبل السفهاء وسفلة القوم، وأبعد عن الحساسيات والاحتكاكات، وأدعى لتذليل الكثير من العقبات أمامها.
التحديات الداخلية للدعوة السلفية
ما أن صدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بآرائه الإصلاحية، ورفع عقيرته بانتقاد البدع ومظاهر الفساد، والعادات الباطلة، وبدأ بعض الناس يتفاعلون معه، ويلتفون حوله، حتى نهض له أصحاب المصالح ورءوس الضلال، وأمراض القلوب، وأولياء الشيطان، على اختلاف نحلهم، وبدعهم، وطرقهم، وأقاموا عليه الدنيا ولم يقعدوها، وردوا سائر أقواله وأفعاله، ونسبوها إلى الضلال المبين، بل ووصل بهم الأمر إلى إغراء رعاعهم به، وتحريضهم لهم على سفك دمه، أكثر مرة، وأجبروه على النزوح من دياره ومسقط رأسه.
ثم بعد ذلك شرعوا في التأليب عليه لدى الأمراء والحكام، كما قاموا بمكاتبة العلماء في الأمصار وبعثوا الوفود إليهم وإلى مواسم الحج، للتحذير من أفكاره، والتنفير من دعوته، وليرسموا لهم صورة مشوهة عنها، وعن صاحبها، وأخذوا يجأروا بالشكوى في كل محفلٍ ويذرفون دموع التماسيح أينما حلو، من البلية التي حلت بدينهم على يديه – بلسان حالهم- فقالوا فيه أنه يحتقر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحط من قدره، ويكره الصالحين، ويكفر المسلمين بغير مكفر، واتهموه بتشويه الدين، ورفع راية الفتنة، والافتئات على السنة، والخروج عن الجماعة، والإتيان ببدعة محدثة مردودة، ورموه بكل صفةٍ شنيعة، وزعموا أنه ضاهى النبوة وادعاها حالا لا مقالا، وألفوا حولها الكتب ونسجوا فيها الأكاذيب والأساطير حول الدعوة وأهلها بالباطل والزور والبهتان.
وقد استطاع المرجفون وعلماء السلاطين، أن يثيروا العديد من الشبهات والكثير من اللغط حول هذه الدعوة الإصلاحية السلفية، ووقفت في طريقها وهي مراحلها الأولى عقبات كثيرة.
وعلى الرغم من أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد استطاع من خلال تحالفه القوي المتين مع محمد بن سعود، أمير الدرعية، أن يتوسع في شرح مبادئ دعوته السلفية الإصلاحية للناس، وفي حثهم على إزالة المنكر، وهدم قباب القبور، وسد ذرائع الشرك، وتحقيق العبودية لله وحده، وبيان معني(لا إله إلا الله)، وذلك من خلال التعليم والرسائل والوعظ ، إلا أن الدعوة مع ذلك قد اصطدمت بالجدار المعنوي السميك، الذي فرضته التقاليد الباطلة والعادات السيئة المتوارثة، التي تأصلت في البيئة، على مدى قرون، وقد شكل هذا العامل التحدي الأكبر في وجه الدعوة على المستوى المحلي والداخلي، فقد أبدى أهل الأهواء والبدع وسدنة القبور، وآكلو السحت ومبتزو أموال الناس بالباطل، وأنصار " إن وجدنا أباءانا على أمة " والزعماء المحليون الذين تكمن مصالحهم في إبقاء الأوضاع دون تغيير، ورأوا في الدعوة تقويضا لنفوذهم، وتهديدا لمصالحهم الذاتية والفئوية الضيقة.
كل هؤلاء أبدوا تشبثا بما كانوا عليه من مظاهر الباطل، واستماتة في الدفاع عنها، والصد عن سبيل الله، وكشروا عن أنياب الغدر والشر، ولم يجدِ معهم الوعظ والنصح، ولم تلق الكلمة الطيبة آذانا صاغية لدى الكثيرين منهم، ولاسيما وأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تقم على الخطب أو الهتافات الحماسية، ولم تلجأ إلى رفع الشعارات البراقة التي تستهوي الرعاع والعامة، وتستثير عواطفهم، أو تغريهم بالحوافز، والجوائز المادية على الالتحاق بها، كما لم تكن إقرارا باللسان فقط، وإنما هي دعوة تخاطب القلوب الحية، والعقول الواعية، والفطرة السليمة، ولا يستجيب لها إلا من وقرت مبادئها في نفسه، وتغلغلت إلى أعماق قلبه، والانتماء إليها ليس كمثل الإنتماء لأي حزب أو جماعة سياسية، وإنما هو انتماء له شروط، ويترتب عليه واجب والتزام، وهو تصديق القول بالفعل، والنظرية بالتطبيق.
كما أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن ممن يقبلون بالحلول الوسط أو ممن يبادرون بتقديم التنازلات، لقاء مكاسب معينة، مادية أو معنوية، وهي التي عادة ما يتهافت عليها أصحاب الدعوات الدنيوية، أو المتقمصين للدعوات الإصلاحية مظهرا وشعارا فقط ، لاسيما إن كان في تلك الحلول أو التنازلات ما يخدش صفاء العقيدة، أو يتعارض مع مبدأ من مبادئ الدعوة التوحيدية.
ومن هنا كان لا بد من إزالة المنكرات ومكافحة عقيدة تقديس الأولياء، وتطبيق شرائع الدين، بقوة اليد والسلطان، إذ أن الله سبحانه وتعالى – كما ذكر عثمان بن عفان – يزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن.
المد السلفي يكتسح جزيرة العرب
وهكذا بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعاونه الأمير محمد بن سعود بإرسال السرايا وجموع المجاهدين من الدرعية إلى خارج حدودها لنشر الدعوة، وتثبيت أركانها في نجد ثم في شبه الجزيرة العربية، لأن البلاد النجدية آنذاك كانت في حالة يرثى لها من الفوضى السياسية– فضلا عن الفوضى الدينية - ولم يكن هناك سلطان جامع أو راية موحدة، وكانت السيادة فيها للأقوى وللأعراف والعادات القبلية السائدة التي تطغى فيها أحكام الجاهلية على أحكام الإسلام.
وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يشرف على العمليات العسكرية بنفسه، ويستمر مع ذلك على الدرس والتدريس، فتوسع في الاتصالات المباشرة بالقبائل والقرى، بزياراته الميدانية المتتالية لها للخطب والمحاضرات في المساجد، واستقبال الضيوف، وتوديع الوفود. والإشراف على أعداد الدعاة، وفي مكاتبة العلماء، لتذكيرهم بالعقد الذي بينهم وبين الله، ورجاء أن يقوموا معه في نصرة دين الله، والاشتراك في الجهاد لاستئصال الشرك والخرافات. وهو مع هذا وذاك مستمر في التأليف فصنف كتبا كثيرة قيمة، أبرزها وأهمها: كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد.
وبفضل الله ثم بفضل مثابرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصبره وجهاده وقوة تحمله، وما كان يتمتع به من العلم والجاه والقبول، إضافة إلى خبرته ووعيه الثاقب، استطاعت الدعوة أن تشكل المجتمع الحاضن لها المؤمن بأفكارها والمستميت من أجلها " وأَلَّفت حكومة، وأوجدت نظاماً مبنياً على الإسلام، ضمن الإطار السلفي" ، وأخذت الدعوة تكتسح القرى، والقبائل، واحدةً تلو الأخرى، وتكتسب المزيد والمزيد من الأنصار.
وفي عام 1178هـ/1773م، تكللت الجهود بفتح الرياض، وبفتحها اتسعت رقعة الأرض التي تخضع للدعوة، والتحق بالدعوة كثير من الناس، وزادت الأموال، وهدأت الأحوال. إلى حدٍ كبيرٍ.
وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شعلة من النشاط والحيوية، ذا إرادة فولاذية، وكان صورة للمجاهد الذي يمضي في فتح البلاد ينشر الدعوة ويزيل مظاهر الشرك التي انحدر إليها الناس، ولم يكن يكلّ أو يمل. وظل " يكافح دون عقيدته، ويعمل لها بلسانه ويده، وبكل قلبه، وبكل عقله، وبكل جهده" حتى آخر يوم في حياته.
وعند ما توفي رحمه الله في عام ( 1206هـ/ 1792م )، كانت الدعوة قد وقفت على أرجلها واشتد ساعدها، وصار لها قوة يُخشى بأسها، وأصبح زمام المبادرة في يد أنصار الدعوة.
فواصلت الدعوة مسيرتها وانتصاراتها التي توجتها بدخول مكة عام 1803م، ثم المدينة المنورة بعد ذلك بعامين. وأخذت الدعوة السلفية تتمدد في شتى أنحاء شبه الجزيرة العربية، وتهاوت تحت ضرباتها حصون البدع حصنا حصنا، وكنست أهل الباطل والزيغ إلى مزبلة التاريخ وبئس المصير.
وفي عام 1806 دخل القواسم حكام الشارقة، تحت نفوذها، فقوي وجودها على سواحل الخليج، وأصبح رجال الدعوة يشكلون تهديدا حقيقيا للأساطيل البريطانية التي كانت قد بدأت تتسلل إلى قلب المياه الإسلامية، مستغلة ضعف الدولة العثمانية وتحت ذريعة الامتيازات التي حصلت عليها منها. كما وصلت الدعوة إلى كربلاء في العراق، سنة 1215هـ، حيث تم هدم القبة التي بناها الرافضة والقبوريين فوق قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما، كما وصلت إلى حوران في بلاد الشام، وخضعت لها شبه الجزيرة كاملة باستثناء اليمن.
وكان من المتوقع، بل من الطبيعي أن تستمر الدعوة بالتمدد وأن تنتشر بين الشعوب المجاورة وحيثما وجد مسلمون، نظرا لحيويتها ولما يتوافر لديها من روح معنوية عالية، ومن مقومات ذاتية عديدة، لولا أن الدولة العثمانية، وقفت في وجهها بكل قوتها وسخرت كل إمكانياتها لضربها، والحرب عليها، وذلك من خلال واليها على مصر العلماني الباطني محمد علي باشا. وكان ذلك لأسباب سياسية بحتة، بعيدة كل البعد عن الدين. وهذا ما يقوله المحققون المحايدون.
وقد يكون للموضوع بقية إن شاء الله.
 الكشف عن تورط الحوثي في إرسال شباب يمنيين للقتال ضد أوكرانيا وما المقابل الذي خدعتهم به روسيا؟
الكشف عن تورط الحوثي في إرسال شباب يمنيين للقتال ضد أوكرانيا وما المقابل الذي خدعتهم به روسيا؟
 تفاصيل قرار السيسي بشأن الإخوان المسلمين… أبرزهم القرضاوي وغنيم ونجل مرسي
تفاصيل قرار السيسي بشأن الإخوان المسلمين… أبرزهم القرضاوي وغنيم ونجل مرسي
 قرارات مصرية مهمة وجديدة تخص رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب
قرارات مصرية مهمة وجديدة تخص رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب
 تفاصيل 350 صاروخا يهز إسرائيل.. حزب الله يفرغ مستودعاته الحربية قبل الاتفاق
تفاصيل 350 صاروخا يهز إسرائيل.. حزب الله يفرغ مستودعاته الحربية قبل الاتفاق
 الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
 قرارات في القبض على مساعدي اللواء شلال شايع بأوامر قهرية من الينابة العامة في عدن
قرارات في القبض على مساعدي اللواء شلال شايع بأوامر قهرية من الينابة العامة في عدن
 قطاع الإرشاد يدشن برنامج دبلوم البناء الفكري للخطباء والدعاة في حضرموت
قطاع الإرشاد يدشن برنامج دبلوم البناء الفكري للخطباء والدعاة في حضرموت
 مكتب المبعوث الأممي يلتقي بمؤتمر مأرب الجامع ويؤكد حرص الأمم المتحدة الاستماع إلى الأطراف الفاعلة
مكتب المبعوث الأممي يلتقي بمؤتمر مأرب الجامع ويؤكد حرص الأمم المتحدة الاستماع إلى الأطراف الفاعلة
 مجلس القيادة يجتمع ويناقش عدة ملفات في مقدمتها سعر العملة والتصعيد الحوثي بالجبهات
مجلس القيادة يجتمع ويناقش عدة ملفات في مقدمتها سعر العملة والتصعيد الحوثي بالجبهات



 طباعة الصفحة
طباعة الصفحة كتابات
كتابات